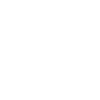تمظهرات اللاشعور
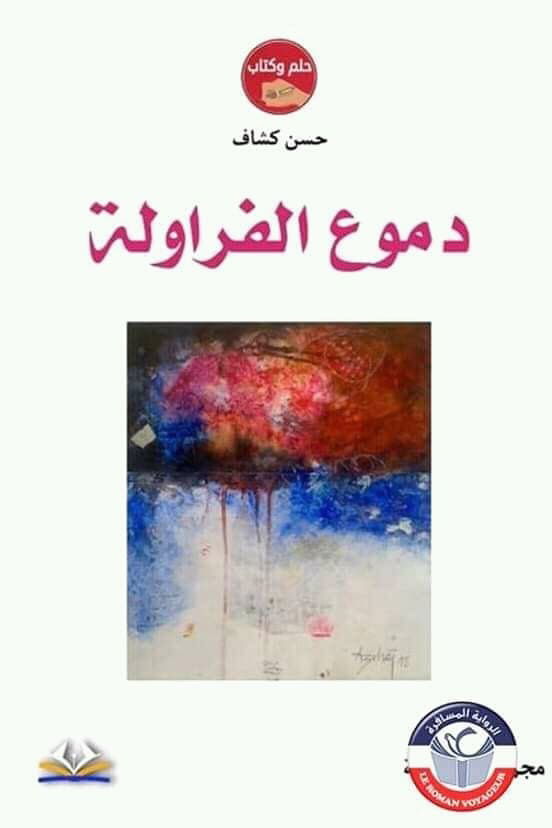
محمد علمي:تمظهرات اللاشعور في المجموعة القصصية "دموع الفراولة " لحسن كشاف
محمد علمي
مقدمة.
يتسع مفهوم الأدب ليشمل مجموعة من الفنون، سواء النثرية أو الشعرية منها، بل والعرضية كالمسرح والسينما أيضا، ولا تقف شمولية الأدب عند هذه الأجناس فقط، ولكنها تتحقق، كذلك، من تعدد موضوعاته التي يشتغل عليها، حيث تصير مادة تخييلية تجعل النص الأدبي صرحا فكريا متباين المشارب والأبعاد. بهذا المعنى، يمكن تبرير الاختلاف الذي تعرفه المقاربات النقدية للنصوص الأدبية، إذ منها ما يسلط الضوء على الملامح الاجتماعية التي أفرزت النص الأدبي، في حين تركز أخرى على بعده التاريخي الذي يتحقق انطلاقا من تموقعه داخل التاريخ، ومن ذلك، أيضا، ما يبئر اهتمامه على الجوانب النفسية أو البنيوية للنص، وغيرها من المباحث النقدية التي يكون النص الأدبي متنا لاشتغالها.بناء على ما تقدم، ستحاول هذه الورقة دراسة مجموعة قصصية موسومة ب: "دموع الفراولة" للقاص المغربي حسن كشاف، متطلعة إلى مقاربتها انطلاقا من تبني مفهوم اللاشعور كما حدده عالم النفس النمساوي سيجموند فرويد، حيث تروم تقصي تمظهرات اللاشعور وتجلياته في هذه المجموعة القصصية بناء على تتبع محايث لبنية النص اللغوية يبلغ إلى استيضاح المحددات النفسية فيها، استنادا إلى الفكرة التي تعتبر اللغة دالة على السلوك ومقترنة بالتفكير ومعبرة عن صراع الذات والمجتمع. وعلى هذا، فإن "اللغة تمثل الرابط الأساس بين الفرد والمجتمع".([1])لتكون، بذلك، سبيلنا إلى دراسة هذه النصوص على هدى مما يمليه النقد النفسي. إذن، فما تجليات اللاشعور من خلال قصص "دموع الفراولة"؟
وفي منحى آخر، تتقصد الدراسة، تتبع انفلات اللاشعور واستقصاء تمظهراته في الخطاب، سعيا منها إلى التحقق من جدوى الأدب في التعبير عن هواجس المبدع وما يؤرقه، وإلى تبيان تمفصلات النصوص الأدبية وعلاقتها بمبدعيها وتصاديها مع البنية النفسية لهؤلاء انطلاقا من الاستعانة بمفهوم اللاشعور كما أورده النقد النفسي.
- البناء المفهومي للدراسة
يتضح، بمقتضى هذا الكلام، أن ذواتنا الإنسانية تتنازعها مناطق مختلفة، حيث لا ينحصر الأمر في كل ما ندركه ونعيه، ولكن هنالك مناطق أخرى تتدخل في تكوين ذواتنا. ومن هذا المنطلق، تنقسم الذات الإنسانية، نفسيا، إلى أربع مناطق أساس هي: الأنا، وهو المسؤول عن الأشياء التي نستطيع إدراكها إدراكا قوامه الوعي بالشيء انطلاقا من سلطة العقل، والهو: وهو موطن الرغبات لدى الإنسان، في حين يمثل اللاشعور موقع الرغبات المكبوتة التي لم تجد سبيلا إلى التحقق فيتم كبتها داخل منطقة اللاشعور، ثم الأنا الأعلى، ويتجلى في تلك السلطة الكابحة، التي تمنع من تحقيق الإشباع، وقد تمثلها الأخلاق أو القوانين أو العادات أو الضمير.
استنادا إلى هذا المعطى،فإن الرغبات التي لا تتمكن الذات الإنسانية من تحقيقها عبر سيرورة تشكّلها لا تموت أوتفنى بشكل نهائي، وإنما يتم تخزينها ضمن بنية اللاشعور إلى حين استدعائها وفق تحققات مختلفة، وبخاصة في شكلتهيؤات أو أحلام مناميةتحلُّ محلَّ الواقع ذاته، إذ إن "الحلم بالنسبة للنائم يكون "حقيقة" تستمر حتى اليقظة، حقيقة لا يشك لحظة في أمرها. فالحلم يبدو واقعا ملموسا وليس بمقدور النائم أن يتبين زيف الصور التي تلم به وتخدعه إلى أن تحل اليقظة فتتبدد الأوهام".([3]) وبذلك، فإن الأحلام تصير حقيقة مؤقتة لدى ذات الحالم، تقوم على محاكاة الواقع المرجعي بشكل مشوّه؛ لأن هذا الواقع في أصله غير حقيقي، وإنما يقدم نفسه على أنه حقيقة.يفضي المعطى السابق إلى القول بأن اللاشعور يعمل على تحويل الرغبات المكبوتة إلى تحققات مزيفة ورامزة تنأى عن المباشرة والتصريح. وهنا نتساءل، ما علاقة الأدب بالأحلام؟
إن الإجابة عن هذا السؤال نجدها في مفهوم اللاشعور نفسه، حيث إن تحقق الغرائز المكبوتة لا يكون عبر الأحلام بحصر القول، بل إن له تحققات أخرى رامزة "منها الفن والأدب، فالأدب، باعتباره نتاجا ثقافيا له وظيفة اجتماعية ونفسية، كما أن محركه الأساس هو الغرائز".([4])بالمعنى هذا، يكون الأدب تمثيلا مقنعا لرغبة مقموعة لدى المبدع، وآلية لتصريف هذه الرغبة وتحقيق الإشباع، وبخاصة أن الأدب يؤسس لبنيات متخيلة تقوم على تمثيل الواقع المرجعي، بحيث يصير النص الأدبي فسيفساء من عوالم ممكنة موازية للواقع المعيش تنبني على فعل التخييلوقوامها اللغة، وغير خاف أن اللغة، في ذاتها، حمالة أوجه ومقترنة بثقافة المجتمع الذي أنتجها. ومن هذا المنظور، فإن الأدب والأحلام سيان، فكلاهما متعلق بالمنع والحرمان، كما أن كليهما يقدم نفسه واقعا بديلا لواقع كائن يكون فضاؤه التخييل.- اللاشعور بنية نصية في المجموعة القصصية دموع الفراولة
إن قراءة فاحصة لنصوص المجموعة القصصية "دموع الفراولة" لحسن كشافتسلم إلى نتيجة أساس مؤداها أن قصص هذه المجموعة تنتظم وفق خيط ناظم يؤطرها، يتعلق الأمر بالإحالة إلى البعد التراجيدي للعالم، حيث تحتكم في موضوعاتها إلى الدلالة على مواضيع ذات أبعاد مأساوية تنتصر إلى تيمات من قبيل: وأد الأحلام، واللصوصية، والمشاكل الأسرية والزوجية، ومعاناة المرأة المغربية، والفقر، وحياة البراريك، والتوظيف بالعقدة في مجال التعليم... وهذه المواضيع، في عمقها، تستمد أسسها من واقع مرجعي موبوء، مما يحيل على عمق المأساة التي تعيشها الذوات الفاعلة في المجموعة القصصية، باعتبار النص القصصي تشييدالعوالم موازية للواقع المعيش.
لقد أدت دينامية البعد التراجيدي المتحكم في المجتمع إلى تكوّن متوالية من الرغبات في ذات المبدع، والتي نجد صدى لها عبر ذوات النصوص القصصية والمسارات التي تعيشها، ذلك أن النص الأدبي يعكس الحاجة إلى تجاوز واقع بئيس سمته التمزق المجتمعي وتشظي العلاقات الاجتماعية وانتشار مظاهر البؤس والشقاء، إنه استجابة موضوعية لرغبة مكبوتة تتجلى في السعي إلى حياة إنسانية كريمة لا فوارق طبقية فيها ولا فقر ولا لصوصية، فكان السبيل إلى تحقيق هذه الرغبة هو عالم النص الأدبي الذي يجعل اللغة آلية لتحقيق هذا المطلب، إذ من خلالها يروم النص إعلاء القيم الإنسانية كالمساواة والتضامن والشعور بالإنسان بوصفه إنسانا قبل كل شيء.
ومن جهة أخرى، نجد توظيف الحلم في القصة المعنونة بـ"غفوة"([5])يستحيل آلية للتوليد السردي، وخلال هذا الحلم تتجلى هواجس الذات الحاملة "رضى"في عوالم موازية تقّدم نفسها بديلا للحقيقة عبر الحلم، إذ إن رضى، ذلك الفتى البدوي الذي انتقل إلى مدينة الدار البيضاء طلبا للعمل يتعرض فيها للسرقة. وبذلك، فقد كوّن عن هذهالمدينة أفكارا تتعلق بما تعرض إليه، حيث إنها، في نظره، مدينة اللصوص وانعدام الثقة، وجراء هذه الهواجس تكونت لديه رغبة دفينة في الانتقام تشربها لاشعورهواستبطنها، ليتم إعادة تحويلها إلى حقيقة مقنعة بواسطة الحلم، ومن ثمة، فإن رضى انتقم من محبوبته التي اكتشف أنها تخونه وتواعد أناسا آخرين غيره، "مقررا إنهاء حياتها، قبل أن تبوء محاولته بالفشل، وتنجو الفتاة بأعجوبة، بعد عدة طعنات على مستوى البطن والصدر".([6])بناء على هذا الحلم، يبدو أن محبوبة رضى تمثل مدينة الدار البيضاء، ويتأتى ذلك من قرينة الغدر التي تعلقت بها، وفي ذلك إحالة إلى ما تعرض له رضى من سرقة، ودليل على فقدان الثقة في كل شيء حتى في الحبيبة التي تعد أقرب المقربين إليه. وعلى هذا، أعاد لاشعور ذات الحالم رضى رغبته في الانتقام من هذه المدينة إلى الحياة وأكسبها تحققا جديدا من خلال الحلم.
واستمرارا في تيمة الانتقام، تتجلى هذه التيمة بعدِّها هوى ملازما للذات الفاعلة في القصة المعنونة بـ: "احتضار ذبابة"، حيث يعيد"عبيدة"إنتاج السلطة التي تمارَس عليه في الملحقات الإدارية من قبل الأعوان والموظفين على ذبابة اقتحمت البراكة التي يقطنها، غير مكترث "لأنينها وصراخها وهي تتوسل إليه لكي يطلق صراحها"،([7])وهذا مظهر آخر من مظاهر تحقيق الرغبة المكبوتة لدى الذات في الانتقام، تلك الرغبة التي تكونت بفعل الواقع الذي يعيش فيه، بما هو واقع سمته القمع والاحتقار، والتعامل مع الإنسان لا بوصفه إنسانا، ولكن باعتباره دون قيمة. إن الرغبة في الانتقام وممارسة السلطة على الذبابة، بكل ما يحمله ذلك من سادية ومتعة،وليد سيرورة من الدونية والاستصغار التي تجعل الذات محط نوعين من الشفقة: شفقة ازدراء من قبل ذوي السلطة، وشفقة مواساة مصدرها تلك الفئات الضعيفة التي تقاسم الذات الفاعلة آلامها وآمالها، هذا الإحساس الذي أعاد لاشعور ذات عبيدة إنتاجه على كائن أضعف منه، فقد "كان في قرارة نفسه يريد أن يدرك ذلك الشعور الذي يخالج كل من يعامله كحشرة دنيئة"،([8])وأن يقلب ثنائية الغالب والمغلوب التي كان يمثل طرفها الأضعف دائما، ليصير الآن غالبا قاهرا ممارسا للسلطة، وبهذا، "فقد أحس بانتشاء عظيم، امتزج بالسلطة والقدرة على إخضاع الآخرين وإخراسهم".([9]) وعلى هذا الأساس، فإن قصتا "غفوة" و"احتضار ذبابة" تمثيل لتمظهرات اللاشعور لدى الذوات الفاعلة في القصة، بل ولدى المبدع أيضا، من حيث كونه صوتا لهذه الفئات ومنتميا إليها، وهذا يؤكد تصور النقد النفسي الذي يرى بأنْ ليس هناك نتاج أدبي دون تدخل اللاوعي في صياغته، فاللاشعور هو مصدر الإبداع، مادام متصلا بذات الفرد وبمجتمعه الذي تشكلت ضمنه هذه الذات. ولماكانت الرغبات الإنسانية المكبوتة في اللاشعور تتحقق عبر المداورة أو المخاتلة تملُّصا من رقابة الأنا الأعلى، كان لزاما أن يستجيب الأدب لهذه الخصيصة، "وهذه بالذات هي حالة الإبداع الأدبي، فهو خطاب واهم، ولكنه يعبر في الوقت نفسه عن رغبة دفينة بطريقة رمزية ملتوية تتحدى المنطوق السطحي للكلام".([10]) تسلمنا ميزة المداورة في الأدب وتجنب المباشرة إلى القول بفكرة أساس أوضحها جاك لاكان، يتعلق الأمر بمفهوم المرآة، حيث يعتبر لاكان"أن مرحلة المرآة تعتبر الانطلاقة الأولى لتعرف الإنسان على ذاته من خلال الآخر"،([11]) فالنظر إلى ذواتنا، بمقتضى هذا التصور، قد تكون ذات الآخر مطيّته التي تسعف على بلوغ كينونة الأنا، مما يصيّر الآخر مرآة لذواتنا، والتعبير عنه تعبير الذات، وهذا ما يتحقق في مجموع القصص الواردة ضمن"دموع الفراولة"حين يتخذ المبدع ذوات أخرى يعبّر بلسانها، ذلك أنه يتقمص دور هؤلاء المقهورين ليتحدث عن ذاته المنغرسة في الجماعة، ولينقل هواجسهم وأحاسيسهم وأوضاعهم البئيسة. ومن ناحية أخرى، تتضح فكرة المرآة من خلال القصة المعنونة بـ: "تعارف فايسبوكي"،([12]) حيث تحكي هذهالقصة عن امرأة في الخمسينيات من عمرها تحنّ إلى زمن الصبا، والصبابة، والولع، والشباب، والحب، فيكون سبيلها إلى ذلك تقمص شخصية أخرى غير شخصيتها الحقيقية، شخصية فتاة شابة حسناء عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. إن هذا التقمص يفضي إلى تأكيد القول الذي يرى بأن الآخر يعكس الذات، إذ إن شخصية الفتاة على الفايسبوك، في الحقيقة، ما هي إلا تعبير واهم عن رغبة مرفوضة لدى الذات الفاعلة، لم يكن لها سبيل إلى الإشباع ما عدا انتحال شخصية أخرى هي شخصية الفتاة الشابة، فتصير، بذلك، الفتاة والعجوز ذاتا واحدة.ينهي التحليل، في هذا المستوى، إلى التأكد من جدوى مقدرة النقد النفسي على تحليل النصوص الأدبية وتسليط الضوء على توترات اللاشعور ومكامن الذات، ومن ثمة، تبرز في نصوص المجموعة القصصية تفاعلات ذات المبدع مع محيطها من ناحية، كما يتضح أنها ليست نصوصا منفصلة عن ذات مبدعها، بل إنها عالم تجسيدي لانفعالات المبدع ولما يشغله، وهذا ما أبرزته طبيعة المواضيع التي سعى إلى معالجتها، وتجسّد من خلال ذوات القصص التي تتأطر في النص بوصفها خاضعة لبنية اللاشعور المتحكمة في أفعالها كما هو الحال مع ذوات رضى وعبيدة وذات المرأة الخمسينية. إن هذه العلاقة الجدلية القائمة على التأثير والتأثر بين المبدع وإبداعه تدفعنا إلى السؤال: أي علاقة للقارئ بهذا الإبداع؟ وهل ينحصر تأثير اللاشعور في النص فقط، أم إن له تجليات أخرى على الذات المتلقية أيضا؟
- أثر النص في نفسية القارئ
إذا كان النقد النفسي قد اعتنى بالمبدع من خلال نصه الأدبي، فإنه لم يغفل المتلقي، وبخاصة إذا ما علمنا بأن الأدب، في عمقه، يناظر بنية المجموعة الاجتماعية التي ينتمي إليها مبدعه. وعلى هذا، يمكن القول، بأن هناك رغبات مشتركة لدى كل من المبدع والقارئ يمكن أن تندرج ضمن ما يعرف باللاشعور الجمعي، فالهواجس والطموحات المشتركة بين المبدع وجماعته الاجتماعية تمثل تحصيلا لهذا اللاشعور المشترك بينهم. ومن هنا، يستمد سؤالنا مشروعيته: أين يتمظهر اللاشعور الجمعي في قصص "دموع الفراولة"؟
لقد سبق وأبرزنا أن الإبداع الأدبي يجسد تحققا لرغبة مكبوتة لدى المبدع، ولمَّا كانت هذه الرغبة تتحقق عبر فعل الكتابة، فإن القارئ يحقق رغباته الغرائزية المكبوتة عبر فعل القراءة؛ لأن الأدب عند فرويد "تلبية خيالية لمجموعة من الرغبات اللاشعورية"،([13])ويتحقق، هذا المعطى، من خلال طبيعة الموضوعات التي تطرقها هذه المجموعة القصصية، وكأنها تدعو القارئ إلى التفاعل معها، وإلى الإحساس بهموم هؤلاء وعيش معاناتهم، إنها تقحمه في عوالم البؤس والشقاء التي يقبع فيها هؤلاء، وتتقاسم معه حياتهم، الأمر الذي قد يجد فيه الكثير من القراء ضالتهم، فتتحقق لديهم تلك الرغبات المشتركة مع المبدع في الحاجة إلى تجاوز الواقع المعيش إلى واقع أفضل.كما أن النصوص الأدبية، قيد الدرس، نجدها، في معظمها، ذات نهايات مفتوحة، تجعل القارئ مدفوعا إلى تحريك قدرته الإبداعية لتأسيس نهاية مفترضة لكل قصة، بعد أن يكون النص قد طرح أمامه بعض تفاصيلها التي تؤثث ذخيرته القرائية، ليذره ومواجهتها بشكل مباشر، تلك النهاية التي سيكون لاشعور القارئ، بموجب النقد النفسي، فاعلا أساسا في اقتراحها، وعنصرا مركزيا في تشكيل مساراتها وصوغ ملامحها.
وبناء عليه، يبدو أن النقد النفسي جعل من القارئ عنصرا مشاركا للمبدع في التأثر بالنص، ذلك أن الأدب يشكل لكل منهما مظهرا لانفلات اللاشعور من رقابة الأنا في تعدديتها، ووفق هذا المبدإ، كانت المجموعة القصصية، قيد التحليل، مثالا لهذا التأثر، إذ لا مناص من مشاركة القارئ لذوات النص في همومها، وبخاصة عند الحديث عن قارئ يشاطر الذوات المآل نفسه.
خاتمة.
لقد سعت هذه الدراسة، إلى الإجابة على السؤال الآتي: ما تمظهرات اللاشعور في نصوص المجموعة القصصية "دموع الفراولة" لحسن كشاف؟ متوسلة، في ذلك، بمفهوم اللاشعور كما أورده النقد النفسي للأدب، من خلال تتبع بنية الخطاب السردي لهذه النصوص، مستعينة بالقرائن اللغوية الدالة عليه في الخطاب. وفي ضوء تحليل نصوص المجموعة القصصية، توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج نجملها في ما يأتي:
- إن نصوص مجموعة "دموع الفراولة" القصصية تستجيب إلى مفاتيح النقد النفسي ومفاهيمه، وتؤكد الفرضية التي انطلقنا منها، حيث تبيَّن أن المواضيع التي ناقشها مبدع النصوص تحتكم إلى خيط ناظم مقترن بالدلالة على عمق المأساة وتراجيديا العالم، كما أن ذواتها الفاعلة، أيضا، محتكمة إلى اللاشعور في القصة.
- تستجيب الذوات الفاعلة في القصص إلى مفهوم المرآة الذي يقوم على استدعاء الآخر بعدّه تمثيلا للذات، إذ إن هذه الذوات تقدم نموذجا لواقع معيش مزر أساسه تفشي التفاوتات الطبقية وانعدام القيم الإنسانية وسيادة قانون الغاب، حيث لا يقام للضعيف وزن.
- لقد أظهرت هذه النصوص أنها تعبير مخاتل عن رغبة ملحّة في تجاوز هذا الوضع الذي يعيشه المبدع بوصفه منغرسا في الجماعة ومبلغا لصوتها، ويعزز هذا التصور دينامية الحوار في القصص وإسلام الكلام للذوات لتعبر عن نفسها، وعن مواقفها وانفعالاتها، فتصير وكأنها ذوات حقيقية نستمع إليها في شكل مسرحي متخيل.
تأسيسا على ما تقدم، تبين أن النص الأدبي ليس نصا اعتباطيا، وإنما مسرحا تتحقق عبره الرغبات المكبوتة والهواجس المفكر فيها، والحاجات والطموحات التي يصبو إليها المبدع وجماعته الاجتماعية. وهنانطرح السؤال الآتي: ماذا عن نصوص الخيال العلمي والسير الذاتية؟ هل يمكن الحديث عن نقد نفسي كلي يشمل بالدراسة والتحليل مختلف النصوص الأدبية أيًّا كانت خصيصاتها؟
مراجع :
([1])حميد لحمداني، الفكر النقدي الأدبي المعاصر، مناهج ونظريات ومواقف، أنفو - برانت، الليدو، فاس، الطبعة الثالثة 2014، ص 111.
([2])حميد لحمداني، الفكر النقدي الأدبي المعاصر، مرجع سابق، ص 87.
([3])عبد الفتاح كيليطو، الغائب، دراسة في مقامة للحريري، دار توبقال للنشر، الطبعة الثالثة 2007، ص 10.
([4])حميد لحمداني، الفكر النقدي الأدبي المعاصر، مرجع سابق، ص 90.
([5])حسن كشاف، دموع الفراولة (مجموعة قصصة)، مرجع سابق،ص 68.
([6])نفسه، ص 70.
([7])نفسه، ص 11.
([8])حسن كشاف، دموع الفراولة (مجموعة قصصة)، مرجع سابق، ص 12.
([9])نفسه، ص 12.
([10])حميد لحمداني، الفكر النقدي الأدبي المعاصر، مرجع سابق، ص 115.
([11])نفسه، ص 113.
([12])حسن كشاف، دموع الفراولة (مجموعة قصصة)، مرجع سابق، ص 64.
([13])حميد لحمداني، الفكر النقدي الأدبي المعاصر، مرجع سابق، ص 95.
*ناقد مغربي