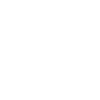في أدبية الخبر والنص الديني .. مُدونة القاضي التنوخي (نموذجا)

د.بلال داوود : في أدبية الخبر والنص الديني .. مُدونة القاضي التنوخي (نموذجا)
-على سبيل التقديم:
كتاب (الفرج بعد الشدة)، من الكتب المعروفة في الأسمار والأخبار، وهو كما يدل العنوان، عبارة عن مجموعة أخبار، عن أُناس ابتلوا أشد البلاء، ثم أصابتهم رحمة من الله، بدلت بؤسهم نعمة، ويقع الكتاب في جزأين، يتضمنان أربعة عشر باباً، ويذكر التنوخي[1] في مقدمة كتابه أنه (جمع فيه أخباراً تنبئ عن رفع البلاء لمن صبر على المحن، وتقوية العزائم على التسليم لله مالك كل أمر، وتصويب رأيه في الإخلاص والتفويض إلى من بيده الملك، ويرجو به انشراح صدور ذوي الألباب من لذة ومصاب ).
وتعتمد قصص الكتاب أحداثاً، تُحول الشخصيات من حال إلى حال، والإشارة لذلك واضحة من العنوان (الفرج بعد الشدة)، وهو نفسه النمط الذي تسير عليه، كل القصص الدرامية التي حفل بها الكتاب، إذ يرى فيها المُطَلّع إما تحولاً من الشقاء إلى السعادة، أو من السعادة إلى الشقاء، ويؤكد (التنوخي) ذلك في مقدمته، ذاكراً أن جميع شخصياته يجري عليها تقلب، (بين شدة ورخاء، ورغد وبلاء، وأخذ وعطاء، ومنع وصنع، وضيق ورهب، وفرج وكرب)، والفكرة الأساسية التي تعتمدها قصص هذا الكتاب، هي أن الإنسان دائم الكد والتعب في هذه الحياة، فهو يصطدم بعقبات كثرة، وعليه أن يجتازها ويتغلب عليها، وينتصر لنفسه، كل ذلك يأتي على شكل حكاية، لها بداية و وسط و نهاية، يتخللها حوار درامي، وتتضمن أحداثاً تشتد لتفصح عن صراع ينتهي، إما بنهاية سعيدة أو شقية. واللافت للنظر عند التنوخي، هو سمة التعالق بين الخبر والنصوص الدينية(القول المأثور عن الأنبياء والرسل والصالحين)، الصادرة عن الرؤية الأخلاقية للكاتب [2]، وهذا التعالق حاضر بقوة في الأخبار الخمس التي قيد دراستنا، فأين يتجلى ويتمظهر؟ وما هي دلالته البلاغية؟ وما العلاقة التي يمكننا ربطها بين الخبر و النص الديني من جهة، و السرد والبيان من جهة أخرى؟
-في تعريف الخبر و النص الديني:
بادئ ذي بدء، أود الإشارة إلى أن مرادنا من إطلاق عبارة (النص الديني)، هو النص الإسلامي، وهو غير محصور عند التنوخي، حيث يتوزع ما بين النص القرآني والنبوي والدعاء والذكر وغيره، فالنص الديني هو المتن السردي الوحيد، الذي بقي محافظا على أصالته وصورته اللفظية الأساس، إذ هو في منأى عن التزييف والتحريف باعتباره جزءا من الذكر الحكيم، الذي تعهد ربنا عز وجل بحفظه مصداقا لقوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)،[3] هذا إضافة إلى بلاغته وبيانه وتقنياته السردية الرفيعة، ونسجه القصصي البديع، وهي كلها من صور بيان القرآن وإعجازه عامة، أما قيمته الخبرية والإعلامية التي وفرها عن السابقين أمما وشعوبا وأفرادا، فهي أمر لا يحتاج بيان.
أما الأخبار فهي أحداث الماضين وأفعالهم وأحوالهم، وما طرأ على أوضاعهم وحياتهم مما يتناقله الرواة، ويتحدث به اللاحقون عن السابقين، أو شاهدو الخبر وسامعوه، وهي في مجال عرضنا هذا ( قصة تحمل معلومة دينية)، ومن ثم فمادتها الأساس تستلهمها من النصوص الدينية. ومن من الملاحظ أن العرب كانوا يعرفون القصة بأسماء عديدة، من أبرزها (الأسمار) و(الخرافة)، ومن الإشارات الدالة على ذلك، أن متى بن يونس في ترجمته "كتاب الشعر" لأرسطو، ترجم ما ترجمه د. شكري عياد في العصر الحديث، "القصة"، مرة بـ (الأسمار) ومرة بـ (الخرافة)، ومرة بـ (حكاية الحديث).[4]
والخبر بالتحريك، واحد الأخبار،(كان الأصل هو الأخبار، لا الخبر) والخبر : ما أتاك من نبا عمن تستخبر. ابن سيدة : الخبر : النبأ، [5] فالأخبار بهذا المعنى وظيفة للعلم، كما قال الجاحظ،[6] يحملها الولي والعدو والصالح والطالح وهي مستفيضة في الناس، لا كلفة على سامعها من العلم بتصديقها.[7]
ويضع سعيد يقطين في كتابه (الكلام والخبر)، الخبر إلى جانب أنواع أصلية وثابتة، من مثل الحكاية والقصة والسيرة. ويؤكد أنها أنواع تقترب من الأجناس الأدبية من حيث طبيعتها وبناؤها. ويقوم فصل يقطين بين هذه الأنواع على مبدأ التراكم. وبذلك يتميز الخبر عنده بكونه أصغر بنية حكائية. وفي إطار توضيحه لهذا المبدأ، ومقارنته للخبر بغيره من الأنواع يقول: (فإذا كان الخبر أصغر وحدة حكائية، فإن الحكاية تراكم لمجموعة من الأخبـار المتصلة، والقصـة تراكـم لمجموعـة مـن الحكايـات، والسـيرة تراكـم لمجموعة من القصـص)[8].
وإذا كان الفصل في مرحلة أولى تم لدى يقطين عبر الاستعانة بمبدأ التراكم، فإننا نجده في مرحلة لاحقة، يتدرج في محاولة الفصل اعتماداً على آليات بنيوية تركيبية، لعل أبرزها: الأحداث والشخصيات، حيث يرى أن الحدث يتصل بالخبر والحكاية[9]. في حين ينصب الاهتمام في القصة والسيرة على الشخصية، وبذلك يكون يقطين قد أفاد ببعض ما يضفي خصوصية على الخبر، لكنه لم يمعن في التدقيق في عناصر جزئية أخرى بنيوية وموضوعية يمكن أن يقوم على أساسها التمييز.
وعندما يتحدث محمد بن إسحق النديم (ت 380هـ)، في مقالته الثامنة، عن أخبار العلماء وأسماء ما صنَّفوه من الكتب، يذكر ثلاثة فنون أولها: (في أخبار المسامرين والمخرِّفين وأسماء الكتب المصنَّفة في الأسمار والخرافات).[10] وهذا يعني جملة أمور: أولها أن القص كان يعد فناً من الفنون، وثانيها أن القص أسمار وخرافات، وثالثها أن الأسمار والخرافات دوِّنت في كتب، ولم تبق مقتصرة على الأداء الشفوي في المجالس، ورابعها أن المؤلفين في هذا الفن كانوا معروفين، ويعدُّون من أصحاب الفنون.
ونتفق مع كلام سعيد يقطين السابق الذكر، باعتبار أن التّنوخي لم يعتمد الموسوعيّة، بل اعتمد السّرد المجرّد دون إسهاب، كما أنّه لا يذكر معلومات تبدو مهمّة عن الشخصيّات الذين يظهرون في الأخبار، بل انصب جل عمله على بناء الحدث، فتحريك السرد في بداية الخبر يتطلب مجموعة من العناصر، التي تساهم في حبك الخبر، نذكر منها: عنصر الإساءة، وهو مهم لتحريك السرد في البداية، ويتتابع باستطراد الأخبار المتعلّقة به حتّى يصل إلى الفرج، مثلا: ذبح العجل من طرف النبي أو الصديق أمام أمه، وخبر خبله، يؤدي في النهاية لتعقل النبي أو الصديق، (أنظر:الخبر الرابع)، هذا إلى جانب ظهور عنصري التشويق والإثارة، حيث تنصّ القصة بأن نبيا أو صديقا ذبح عجلا بين يدي أمه، وأثناء قيامه بذبح العجل خبل وذهب عقله، وذات يوم قام النبي أو الصديق بمصادفة فرخ طائر وقع من وكره في التراب، فقام النبي أو الصديق بمسحه، وإعادته لوكره، فدعا الطائر للنبي أو الصديق، فرد الله عز وجل عليه عقله، نرى كيف أن الخبر قام على فكرة الإحسان. نُضيف إلى ما قلنا أعلاه عنصرا هاما آخر، هو عنصر الاختبار- اختبار الشخصيّة في الحدث- وهو عنصر فنيّ، والاختبار لدى الشخصية قد يجعل منه ضحية، وقد يجعل منه الفاعل في الضحية، وفي الخبر الرابع نجد أن عنصر الاختبار هو الفاعل في الضحية، ويتمثل في: (فرخ الطائر الذي وقع في الأرض، والطائر الذي ظل يطير فوق رأس النبي أو الصديق). ويحمل الخبر مفهوما عجائبيا(الخبر الرابع أنموذجا)، كما تحدث عن ذلك عبد القاهر الجرجاني، فوصف الخبر بالأصل الأول، وأنه أعظم المعاني شأنا، إذ يقول: (اعلم أن معاني الكلام كلها معانٍ لا تتصور إلا في ما بين شيئين: والأصل الأول هو الخبر...(ويضيف فيقول: "إن الخبر وجميع معاني الكلام معان ينشئها الإنسان... وأعظمها شأناً الخبر فهو الذي يتصور بالصورة الكثيرة، وتقع فيه الصناعات العجيبة).[11]
-في المضمون:
ينقل لنا التنوخي أخباره، تحت عناوين[12] معينة )واصفة للنص الأدبي)، ومن بينها :
- دعاء داود عليه السلام .
- ذبح عجلا بين يدي أمه فخبل.
إن ما يهمنا الآن هو تفهم طبيعة هذه النصوص السردية القصيرة، وليس القصد إفراغها من معناها، بل إثبات أن هناك مساحة مشروعة داخل النص الديني، قام التنوخي باستغلالها وربطها بأخباره، لتُعبر عن الواقع أو تُحاكيه، وقد تطلب منا ذلك مسايرة أخبار[13] التنوخي، التي تنقل لنا حكايات[14] كاملة، لها بداية ونهاية، ذات حمولات دلالية عالية، تقوم على علاقة مكونة من ثلاثة أبعاد هي: الطلب، ثم المنع، ثم الانفراج والخروج من المأزق،[15] عبَر الكاتب عن هذه العلاقة من خلال عنوان الكتاب نفسه (الفرج بعد الشدة)، فالأحداث التي تقود إلى الشدة، دائما يتبعها الفرج. يقول الدكتور سعيد جبار مُستكنهاً الملامح التي يتميّز بها الخبر عن غيره: (الخبر على عكس الأنواع السردية الأخرى المركبة ينمو أفقياً فقط، في حين تنمو الأنواع الأخرى أفقياً وعمودياً. وتتمثل بساطة الخبر في هذا الانتقال السريع بين الوظائف التي تربط البداية بالنهاية، في مساحة خطابية لا تتجاوز أحياناً السطرين أو الثلاثة. وهذا ما يجعل الحدث في الخبر بسيطاً، كما يجعله بؤرة الفعل السردي بصفة عامة. وبساطة الحدث ووحدته تنعكس على البنية الزمانية والفضائية، التي لا تتجاوز هي الأخرى هذه البساطة، وبالتالي فبساطة النوع تنعكس على الثوابت الحكائية، التي تدعم هذه البساطة وتؤكدها)[16]. وسنقف في هذه العجالة على عدد من أخبار التنوخي، بما اشتملت عليه من اتساع المعنى وإحكام الأسلوب، مع اجتماع الكلام وقلّة الألفاظ.
قال ابن أبي الدنيا، قال حدثنا أبو نصر التمار، قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي، قال: قال داود عليه السلام: سبحان الله مستخرج الدعاء بالبلاء، سبحان الله مستخرج الشكر بالرخاء.
هذا الخبر عبارة عن نص ديني يتميز بالبساطة[18]، يقدم إجابات مقنعة عن التساؤلات التي تؤرق المتلقي المفترض، في بحثه عن القوى التي تتحكم في البلاء والرخاء، فالدعاء هو فعل الكلام الذي تجتمع فيه أفعال جزئية، كالطلب بالأمر والنداء والشرط، وهي وسائل تمتلك الكفاءة اللازمة التي يتم بها تحقق النشاط الخطابي، وضمان المشاركة وإحداث الأثر، لما يحمله (الدعاء) من قوة كلامية تريح المتلفظ به، لأنه فعل الكلام الذي لا يتحقق إلا بالتلفظ به، لذلك قال أبو علي الدقاق: الدعاء مفتاح الحاجة، وهو مستروح أصحاب الفاقات، وملجأ المضطرين، ومتنفس ذوي المآرب، وقد ذم الله تعالى قوما تركوا الدعاء، فقال: (ويقبضون أيديهم) قيل لا يمدونها لنا بالسؤال.[19]
وبذلك يسهم الدعاء في فرض شروط التخاطب، ومن ثم ضمان استمراره، فكان فعل الدعاء إذن، بمثابة الدعامة الأساسية التي حقق بواسطتها التنوخي التماسك لخبره. وسر البيان في العبارة كلها لفظة(مستخرج) التي تتكرر مرتين، وهذا كله تصوير لدقائق معنى الفرج بعد الشدة، وقد صدر الخبر عن حجاج للسلطة، حيث كثر استخدام الحجج في خدمة السرد في عصرالكاتب (القرن الثالث)، أحد العصور الأكثر بلاغية.
فالتنوخي شحن خبره بنص ديني[20]، تمثل في دعاء سيدنا داود، هذا الأخير الذي يُمكننا اعتباره، عنصرا بلاغيا[21] قائما في الخبر، من خلال قول سيدنا داود[22]: سبحان الله مستخرج الدعاء بالبلاء، سبحان الله مستخرج الشكر بالرخاء. ويجري على هذه الشاكلة أسلوب (الفَرج بَعدِ الشِدة)، كونه أسلوب أدبي إخباري، لزم جانب العظة والعبرة.
2- ذبح عجلاً بين يدي أمه فخبل:
حدثنا إبراهيم بن محمد الأنصاري، بالموصل، بحضر عضد الدولة، قال: أنبأنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي القاضي، وأبو جعفر محمد بن محمد بن حبان الأنصاري، البصريان، قالا: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي، قال: حدثني حماد بن سلمة. قال: حدثنا أبو عمران الجوفي عن نوف البكالي: أن نبياً أو صديقاً ذبح عجلاً بين يدي أمه، فخبل، فبينما هو كذلك ذات يوم، تحت شجرة فيها وكر طير، إذ وقع فرخ طائر في الأرض، وتغبر في التراب، فأتاه الطائر، فجعل يطير فوق رأسه، فأخذ النبي أو الصديق الفرخ، فمسحه من التراب، وأعاده في وكره، فرد الله عز وجل عليه عقله.
نَلحظُ اعتماد صوت الخطاب السردي في الحكاية على راو كلي العلم، استعان بالشهود (الأخبار اليقينية)، لنقل حكايته ففي مطلع السرد يقول: (بحضرة عضد الدولة)، ثم يسرد لنا ما قرأه أو سمعه من خلال الخطاب المحول، والخطاب المستحضر، فنقل لنا كلام الشخصيات إلى الأسلوب غير المباشر، و يبرز أيضا دور الراوي العليم، من خلال سبر أعماق الشخصيات واستقصاء بواطنها، إذ يرصد لنا حديث طاووس مع علي بن الحسين عليهما السلام، وما الحوار المضمن في النص إلا امتداد للسرد والوصف، يستخدمه التنوخي وسيلة للإبلاغ، وأحياناً يحل الحوار مكان السرد الحكائي بشكل تام، فيتخذ المتحاورون مظهراً يعتمد السرد المستمر، ويبدو القص في جانب منه على شكل خطابات لغوية متقطعة لا ترتقي إلى مستوى السرد، ولكن تشكيل السرد يعتمد مبدأ السببية، التي تجعل كل سبب يحيل إلى نتيجة وكل حدث يفضي إلى آخر.
ولتحقيق الانفراج تتم الاستعانة بعوامل مساعدة منها قرب النعيم، إيذاناً ببدء حياة جديدة، ومجيء الفرج من هذا الكرب والبؤس، ونلحظ في النص، تلك المفارقة بين بداية الحكاية وخاتمتها، فالنبي هو الذي ذبح العجل بين يدي أمه، وهو أيضا الذي مسح الطائر من التراب وأعاده إلى وكره حرصا عليه، وعمل على حمايته حتى تنجلي الغمة عنه. وقد لجأ التنوخي إلى الطائر، فكان خير عون له، في تحقيق مقصديته، بطريقة مبدعة.
ولا تحاول الحكاية أن تكشف لنا عن خفايا خبل النبي، بل اكتفى الكاتب بممارسة دور الراوي الإبعادي، فاستعان بكل الأحداث التي تلصق صفة الخبل بالنبي، ومهما يكن فالحكاية تروي أحداثاً يفترض أنها وقعت في زمن ما،(سلطة الأسطورة). كما يحيل النص، إلى أسس العملية التواصلية بشتى وظائفها، فالمعاني المستورة والخفية، لا يتم التعرف عليها إلا بالاستعمال، أي (بالألفاظ)، وكذلك بالإخبار عنها، أي الإبانة أو البيان.
والخبر الذي بين أيدينا تام، فهو يشتمل على سارد معين (التنوخي )، ورواة معلومين (إبراهيم بن محمد الأنصاري، عضد الدولة، أبو خليفة الفضل، أبو جعفر محمد، .. نوف البكالي)، ومذكور(هو النبي أو الصديق)، وموضوع (وهو خبل الصبي فور ذبحه العجل بين يدي أمه، وتعقله بعد الإحسان بفرخ الطائر)، وعلى صيغ التحمل والإسناد (حدثنا، قال، أنبأنا، عن).[23] دمج التنوخي هذه العناصر السردية في خبره، فجاءت قوية التصوير(تصويرا أخلاقيا)، ورائعة الأداء. تحكي أحداثا خارقة ذات مرجع تاريخي، تنتظم في سياق خيطي غير محكم الحبك، غني بالمفاجآت والمبالغات وإثارة الخوف، فمثلاً يصل البطل إلى الخبل، ثم ينجو بعمل بطولي، والنهايات تتحول بدايات في سلسلة متصلة الحلقات. والمبدأ الذي يحركها وينظمها هو مسار سعي البطل إلى تحقيق بطولته وانتصاره.
-خاتمة :
(الفرج بعد الشدة) مؤلف جُملُه تحمل جمالا في ذاتها، وأخباره ممتعة، ضَمنها التنوخي مجموعة من الخطابات المتداخلة(الخطاب السردي والحجاجي والديني). فأخبار التنوخي تجعل من الحياة كلها مادة لها، جعلها التنوخي أقرب ما تكون إلى طبيعة الروح، تملأ روح متلقيها بالفرج وتحقيق ما يصبو إليه، فاندمجت بذلك أخبار التنوخي بفلسفتها وأخبارها، اندماجا تاما في النسق الثقافي العربي، وفيما وراء ذلك في النسق الثقافي الإنساني، كونه يؤطر التجربة الإنسانية عامة ويكيفها، باعتباره يتجاوز الزمان والمكان، وله صلاحية مطلقة وشمولية، يستمدها من النصوص الدينية (الأصل السماوي الرباني)، في تواز مع وجود كم أسطوري وخرافي لا يستهان به في التراث العربي، تَمَظهَر سردياً ليعبر عن إشكالات وجودية وجمالية، إذ رأينا كيف ساهم السرد في إظهار غايات متعددة في الخبر (في خدمة الدين، والحجاج، والتعليم، والبلاغة والبيان..). فالبيان هو الكفيل بإتقان الحبكات والصياغة الحسنة، لعلاقة الإنسان بالموجودات الأخرى، ومحاكاة العالم وإعادة إنتاجه، أي محاولة فهمه وقراءة الوجود، وغاية هذا الوجود، وهو الفهم الذي كيفته الشرائع والمعتقدات منذ القديم، فشكل بذلك فن الخبر مجالاً هاماً في السرد العربي القديم، ويمكن اعتبار هذا الأخير، المعبر الأساسي عن الخصوصية الشفوية للسرد في مظاهرها الأولى والبدائية، ففي فضاء بدوي ذي نزعة شفاهية، تؤثر السرعة والارتجال والتلميح الخاطف، يأتي الخبر ليلبي هذه النزعة بكل شموليتها وخصائصها.
الهوامش:
[1]- مؤلّف كتاب الفرج بعد الشّدّة، وهو المحسّن بن عليّ بن محمّد التّنوخيّ البصريّ(329هـ/384هـ)، من أكبر القضاة الأدباء في عصره، له مؤلّفات عديدة أهمّها نشوار المحاضرة، جامع التّواريخ والفرج بعد الشّدّة، أنظر: خير الدّين الزركلي، الأعلام، بيروت، دار العلم للملايين،1425هـ/2005م، ص: 288.
[2]- بل حتى فيما يتعلّق بالتّبويب، فالتّنوخي لا يعتمد على تبويب منظّم يراعي المنطق في تبويبه، حيث جاء التّبويب تدرجا تفاضليا قيميّا، ينمّ عن نزعة دينيّة أخلاقية لدى القاضي التّنوخي، فقد أورد بابا لقصص الأنبياء، ثمّ عن الأخبار والآثار، ثمّ ذوي الخلافة، وفي آخر الأبواب ذكر العشق والهوى ممّا يعكس نزعته الدّينيّة.
[4]- كتاب الشعر، لأرسطو، انظر: )ص: 28-29-63(.
[5]- لسان العرب، لابن منظور، ص:277-4.
[6]- رسالة المعاش والمعاد، للجاحظ، ص:119.
[7]- رسالة كتمان السر وحفظ اللسان، للجاحظ، ص:143.
[8]- الكلام والخبر (مقدمة للسرد العربي)، ص : 195.
[9]- نفسه.
[10]- الفهرست، لابن النديم، ص:363.
[11] -دلائل الإعجاز في علم المعاني، لعبد القاهر الجرجاني، ص:405-407.
[12]-تنييه: ومن المُرجح أن تكون هذه العناوين من عمل المحقق.
[13]-أستعملُ مفهوم الخبر باعتباره الوحيد من بين المفاهيم الأخرى(القصة-القصص-الحكاية..)الذي يحتفظ بطابع العمومية والشمول، ويمكن أن يتسع ليشمل من جانب الحكاية والقصة، ومن جانب آخر السيرة، وما إلى ذلك من المفاهيم الأخرى التي يميزها الطابع الإخباري أو السردي.
[14]-الحكاية لفظ عام يدا على قصة متخيلة،أو على حدث تاريخي خاص،بهدف إلقاء الضوء على خفايا الأمور أو على نفس البشر. كما يدل على أي سرد منسوب إلى راو.
[15] - أي ما يسمى بالبناء الشعوري للنص الديني، فلا نستطيع حقا أن نجرد هذه المسحة الدينية من على أخبار التنوخي، فهي تحتل مساحة شاسعة من النصوص التي نصادفها في كتاب(الفرج بعد الشدة). بل في الثقافة العربية القديمة جميعا.
[16]- الخبر في السرد العربي: الثوابت والمتغيرات، لسعيد جبار، ص:218.
[18]- فـ«البساطة التيمية هي مفهوم مركزي تساهم في تمييز الخبر عن الأنواع السردية الأخرى»، الخبر في السرد العربي: الثوابت والمتغيرات، لسعيد جبار، ص: 218.
[19]- الرسالة القشيرية، لعبد الكريم القشيري، ص:119.
[20]-ويشتركان معا(أي الخبر والنص الديني) في صفة التواصلية، حيث يقتضي كل واحد منهما وجود مرسل ومتلق.
[21]- يمثل البيان المحور الرئيسي للنظرية البلاغية، إذ استقطب اهتمامه الفكري، وأضحى المعادل الموضوعي لعلاقة اللغة بالمتكلمين في السياقات المعينة، والبيان -عند التنوخي- اسم جامع لكلّ شيء كشف لك قناع المعنى، حتّى يفضي السّامع إلى حقيقته، ويهجم على محصوله، كائناً من كان ذلك البيان، ومن أي جنس كان الدّليل.
[22] -الخبر قابل لأن يستوعب مجموعة من النصوص المختلفة، التي تلتقي جميعها في الطبيعة الخبرية، حيث يستوعب النص القرآني، وأحاديث الأنبياء، اللذان يمثلان أحد النصوص الأساسية التي ارتكزت عليها الثقافة العربية الإسلامية، وعلومها المختلفة في اللغة والأدب وعلوم الدين، وقد استدل التنوخي بآيات القرآن وبأحاديث الأنبياء والرسل، بغية استخلاص العديد من المعاني اللغوية لكلمة من الكلمات، فهما يمثلان مصدرا للإعجاز، سواء على مستوى البلاغة أو اللغة أو المضامين، ولذلك نجد حضور النص الديني قويا في أخبار التنوخي، ويمثل مصدر استشهاد واستدلال.
[23]- يُؤدي القص راو عليم متحكم، يروي عن رُواة يسميهم، ليُوهم بصدقيته.
فــهرس المــصادر والمـــراجع:
- القـــــــــــــــــــــــرآن الكريــــــــــــــــــم.
- الأعلام، لخير الدّين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، 1425هـ/2005م.
- الأغاني، لأبي فرج الأصفهاني، دار الكتب العلمية، بيروت، 1412هـ/1992م. 8 أجزاء.
- -البلاغة والأدب، من صور اللغة إلى صور الخطاب، د محمد مشبال، دار العين للنشر، الإسكندرية. الطبعة الأولى: 1431هـ/2010م.
- البلاغة والسرد، جدل التصوير والحجاج في أخبار الجاحظ، د.محمد مشبال، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة عبد المالك السعدي، تطوان المغرب،1431هـ/2010م.
- جمع الجواهر في الملح والنوادر، للقيرواني، تحقيق وضبط: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، د.ت.
- الخبر في الأدب العربي: «دراسة في السردية العربية»، محمد القاضي، دار الغرب الإسلامي، ط1، 1418هـ/1998م.
- الخبر في السرد العربي: الثوابت والمتغيرات، لسعيد جبار، مجموعة المدارس، الدار البيضاء، الطبعة الأولى: 1424هـ/2004م.
- دلائل الإعجاز، في علم المعاني، لعبد القاهر الجرجاني، صحح أصله الشيخان محمد عبده، و محمد محمود الشنقيطي، وصحح طبعه وعلق حواشيه محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، 1401هـ/1981م.
- الرسالة القشيرية، لعبد الكريم القشيري، تحقيق أحمد عناية ومحمد الإسكندراني، دار الكتاب العربي، لبنان، 1424هـ/2004م.
- رسائل الجاحظ، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة 1385هـ/ 1965م.
- السرد العربي القديم: الأنواع والوظائف والبنيات، لابراهيم صحراوي، منشورات الاختلاف، الجزائر، الطبعة الأولى، 1429هـ/2008م.
- الشعر، لأرسطو، حققه وترجمه د. شكري عياد، دار الكاتب العربي، القاهرة، 1386هـ/1967م.
- الفرج بعد الشّدّة، المحسّن بن علي التّنوخي، تحقيق: عبّود الشّالجي، بيروت، دار صادر، 1398هـ/1978م.
- الفهرست، لمحمد بن إسحق النديم، تحقيق رضا ـ تجدد المازندراني، طهران، 1391هـ/1971م.
- نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، للتنوخي البصري، تحقيق مصطفى حسين عبد الهادي، دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - الطبعة الأولى، 1424هـ/2004 م، عدد الأجزاء: 2.